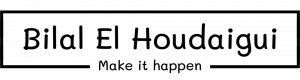مراجعة كتاب الإسلام بين الشرق والغرب للكاتب علي عزت بيغوفيتش
مقدمة عن الكاتب
ولد بيجوفيتش في مدينة بوسانا كروبا البوسنية، تعلم في مدارس مدينة سراييفو وتخرج في جامعتها في القانون، وعمل مستشارًا قانونيًا خلال 25 عامًا، ثم اعتزل بعدها وتفرغ للبحث والكتابة.
تسلم بيجوفيتش رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك من 19 نوفمبر 1990م حتى 1996 ومن ثم أصبح عضوا في مجلس الرئاسة البوسني من 1996 إلى 2000.
حين تم اختياره رئيسا للبلاد لم تقتصر إنجازاته على مقاومة عدوان القوات الكرواتية والصربية، بل امتدت جهوده إلى بعث الهوية الإسلامية في داخل الشعب البوسنوي.
أجاد بيجوفيتش التحدث بعدة لغات من بينها الألمانية والفرنسية والإنجليزية. كتب عدة مؤلفات نالت شهرة عالمية وترجمت إلى عدة لغات أهمها : (الإسلام بين الشرق والغرب) ، ( مشاكل الإحياء الإسلامي) ، ( الإعلان الإسلامي) ، ( هروبي إلى الحرية) ، ( ذكريات).

مقدمة عن الكاتب
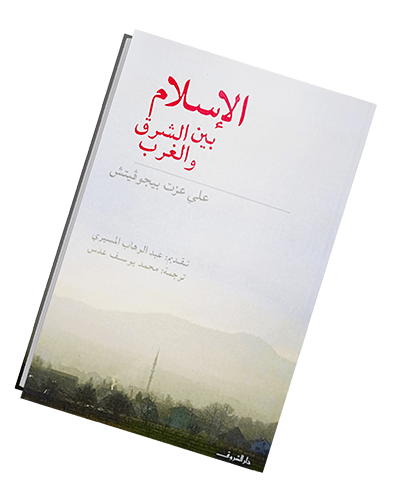
صراحة أستحي من كتابة ريفيو عن هذا الكتاب العظيم، الاسلام بين الشرق والغرب، كتاب كلما قرات صفحة من صفحاته وسبرت اغواره تاكدت من اني اقرا كتابا ليس كغيره من الكتب، كتاب من النوع الذي وانا أقرا فقراته اتوقف وأتامل قوة الكلمات ورقيها، في بداية قراءتي للصفحات الاولى ادركت انني وقعت على كنز تحسرت على عدم قراءته من قبل لكن اظن انني ما كنت سافهمه على كل حل، وحتى هذه اللحظة وبعد ان قراته، انا على على يقين انني لم استوعبه كاملا.
في لحظة من اللحظات توقفت اتامل كلمات الكاتب فوجدته كأنما يقول لي : نحن خلقنا من وحدتين، الجسم الفيزيائي الدي نستطيع لمسه وهو بمثابة الهاردوير، والروح التي يمكن اعتبارها ك السوفتور, الهاردوير يحتاج الى غداء صحي ومناسب فالعقل غداءه العلم والجسم غداءه الطعام اما الروح فغداءها الدين، وكما أن الغذاء فيه الضار والنافع فالدين اي السوفتور الذي يسمح للروح بأن تكون في افضل حالاتها هو الاسلام. ونفي وجود الخالق هو نفي الدين ونفي هذا الأخير يلغي جزءا اساسيا لايتجزء من النفس البشرية.
خلال قراءتي للجزء الثاني من الكتاب اختلطت في نفسي مشاعر الحب والتقدير مع الحسرة والحزن، حب وتقدير لهذا الدين العظيم، وحزن وحسرة لعدم ادراك أغلب المسلمين لمدى عظمته.
عندما شارفت على إنهاء الكتاب شعرت وكأنني سأفقد صديق عزيز على قلبي وتمنيت ألا ينتهي .. رحمك الله يا علي عزت بيجوفيتش وأسكنك فسيح جنانه.
اقتباسات من الكتاب

يرى علي عزت بيجوڤيتش أن هناك ثلاث وجهات نظر عن العالم:
- الرؤية المادية التي ترى العالم باعتباره مادة محضة، وهي فلسفة تنكر التطلعات الروحية للإنسان. والاشتراكية مثل جيد على هذه الفلسفة، فهي تقدم خلاصا خارجيا فقط (من خلال الاستهلاك وتحسين مستوى الدخل أو تغيير البيئة الاجتماعية… إلخ).
- الرؤية الدينية المجردة (أو الروحية الخالصة)، وهي رؤية للدين باعتباره تجربة روحية فردية خاصة لا تذهب أبعد من العلاقة الشخصية بالله، وهذه الرؤية تنكر الاحتياجات المادية للإنسان. والمسيحية مثل جيد على هذه الرؤية، فهي تقدم خلاصًا داخليًّا فحسب. إن أي حل يغلّب جانبًا من طبيعة الإنسان على حساب الجانب الآخر من شأنه أن يعوق القوى الإنسانية أو يؤدي إلى الصراع الداخلي. فالحياة، كما يقول علي عزت بيجوڤيتش، «مزدوجة، وقد أصبح من المستحيل عمليًا أن يحيا الإنسان حياة واحدة منذ اللحظة التي توقف فيها أن يكون نباتًا أو حيوانًا».
- ثمة رؤية ثالثة تعترف بالثنائية الإنسانية، وتحاول تجاوزها عن طريق توحيد الروح والمادة، وهذه هي الرؤية الإسلامية. إن الإسلام يخاطب كل ما في الإنسان ويتقبله. ويرى علي عزت بيجوڤيتش أن الإسلام وُجد قبل الإنسان، وهو ـ كما قرر القرآن بوضوح ـ المبدأ الذي خُلق الإنسان بمقتضاه، ومن ثم نجد انسجاما وتطابقا فطريا بين الإنسان والإسلام. «الإنسان هو وحدة الروح والجسد، [وكذا] الإسلام.. [فهو أيضًا] وحدة بين الاتجاه الروحي والنظام الاجتماعي، وكما أن الجسم في الصلاة يمكن أن يخضع لحركة الروح، فإن النظام الاجتماعي يمكن بدوره أن يخدم المُثل العليا للدين والأخلاق». إن الإسلام انطلاقا من إدراك ثنائية الإنسان «لا يتعسف بتنمية خصال لا جذور لها في طبيعة الإنسان. إنه لا يحاول أن يجعل منا ملائكة؛ لأن هذا مستحيل. بل يميل إلى جعل الإنسان إنسانا. في الإسلام قدر من الزهد، ولكنه لم يحاول به أن يدمر الحياة أو الصحة أو الأفكار أو حب الاجتماع بالآخرين، أو الرغبة في السعادة والمتعة. هذا القدر من الزهد أريد به تحقيق التوازن في غرائزنا، أو توفير نوع من التوازن بين الجسد والروح. إن القرآن يتناول الغرائز متفهما لا متهما، ولحكمة ما سجدت الملائكة للإنسان. ألا يشير هذا السجود إلى معنى تفوق ما هو إنساني على ما هو ملائكي؟». هذه الثنائية هي سبب سوء فهم العقل الغربي لهذا الدين، وهو سوء فهم لا يزال مستمرًا إلى هذا اليوم، «فمن جانب الدين [الروحي المجرد] اتُّهم الإسلام بأنه أكثر لُصوقًا بالطبيعة والواقع مما يجب، وأنه متكيف مع الحياة الدنيا. واتهم من جانب العلم أنه ينطوي على عناصر دينية وغيبية. وفي الحقيقة هناك إسلام واحد وحسب، ولكن شأنه شأن الإنسان له روح وجسم. فزعم التعارض فيه يتوقف على اختلاف وجهة النظر. فالماديون لا يرون في الإسلام إلا أنه دين وغيب، أي اتجاهًا «يمينيًّا». بينما يراه المسيحيون فقط حركة اجتماعية سياسية، أي اتجاهًا «يساريًّا»! وفي واقع الأمر، ليس الإسلام هذا ولا ذاك، وإنما هو يجمع بينهما في كلّ واحد متكامل متوازن.
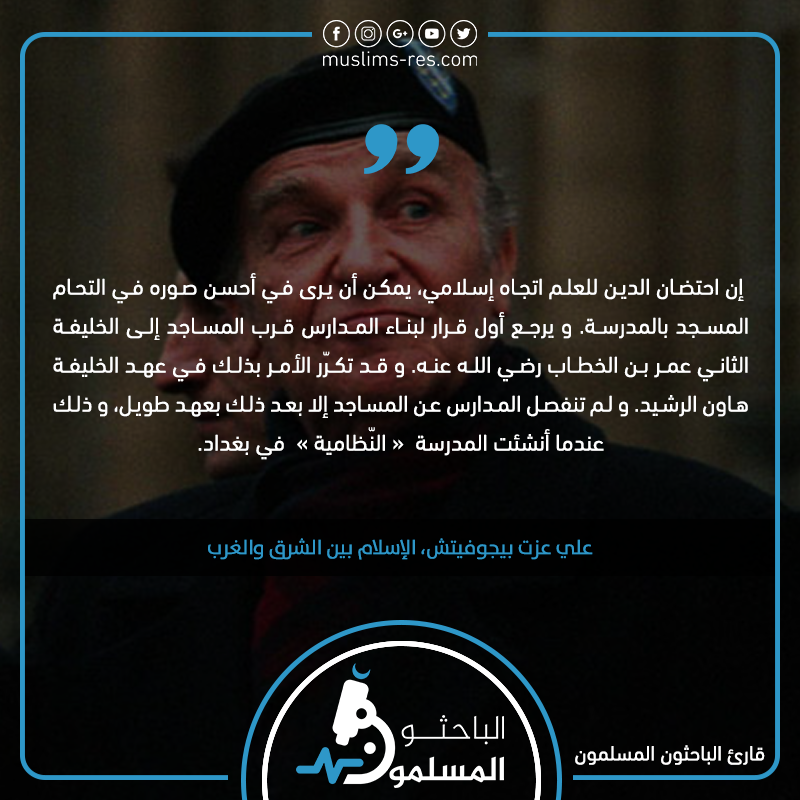
كيف يمكن تفسير التباين الظاهري التالي: إذا وجدنا في اكتشاف أثري حجرين موضوعين في نظام معين أو قُطِعا لغرض ما، فإننا جميعًا نستنتج بالتأكيد أن هذا من عمل إنسان في الزمان القديم، فإذا وجدنا بالقرب من الحجر جمجمة بشرية أكثر كمالاً وأكثـر تعقـيدًا من الحجر بدرجة لا تُقـارن، فإن بعضًا منا لن يفكر في أنها من صنع كائـن واع، بل ينظـرون إلى هذه الجمجمة الكاملة أو الهيـكل الكامل كأنهما قد نشآ بذاتهـما أو بالصدفة ـ هكذا بـدون تدخـل عقل أو وعي. أليس في إنكار الإنسان لله هوى بيِّن؟
يشيع بين بعض الناس الذين يقرأون القرآن بعقلية نقدية تحليلية انطباعٌ بأن القرآن من الناحية الموضوعية لا يتبع نظامًا محددًا، ويبدو وكأنه مركب من عناصر متناثرة. ولكن، لا بد أن يكون مفهومًا بادئ ذي بدء، أن القرآن ليس كتابًا أدبيًا وإنما هو حياة. والإسلام نفسه طريقة حياة أكثر من كونه طريقة في التفكير. إن التعليق الوحيد الأصيل على القرآن هو القول بأنه «حياة»، وكما نعلم كانت هذه الحياة في نموذجها المجسد هي حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام في صيغته المكتوبة (أعني القرآن) قد يبدو بغير نظام في ظاهره، ولكنه في حياة محمد صلى الله عليه وسلم قد برهن على أنه وحدة طبيعية: من الحب والقوة، المتسامي والواقعي، الروحي والبشري. هذا المركّب المتفجر حيوية من الدين والسياسة يبث قوة هائلة في حياة الشعوب التي احتضنت الإسلام. في لحظة واحدة يتطابق الإسلام مع جوهر الحياة.
يُعنى الإسلام بالدعوة إلى خلق إنسان متسق مع روحه وبدنه، ومجتمع تحافظ قوانينه ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية على هذا الاتساق ولا تنتهكه. إن الإسلام هو ـ وينبغي أن يظل كذلك ـ البحث الدائم عبر التاريخ عن حالة التوازن الجُوَّاني والبرَّاني. هذا هو هدف الإسلام اليوم، وهو واجبه التاريخي المقدر له في المستقبل
هذه الأسئلة تجعلنا نتشكك فيما إذا كانت الصورة التي رسمها العلم كاملة؟ إن العلم يعطينا صورة فوتوغرافية دقيقة للعالم، وإن كانت تفتقر إلى بُعد جوهري للواقع. حيث يتميز العلم بفهم طبيعي خاطئ لكل ما هو حي وكل ما هو إنساني. إنه بمنطقه التحليلي المجرد يجعل الحياة خِلوًا من الحياة، ويجعل الإنسان خلوًا من الإنسانية. إن العلم في علاقته بالإنسان ممكن فقط، إذا كان الإنسان حقًا جزءًا من العالم أو نتاجًا له. بمعنى آخر، أن يكون شيئًا. وعلى عكس ذلك، الفن ممكن فقط إذا كان الإنسان مختلفًا عن الطبيعة، إذا كان غريبًا فيها، إذا كان هوية متميزة، فكل الفنون تحكي قصة متصلة لغربة الإنسان في الطبيعة.
إن الكائن الإنساني ليس مجرد مجموع وظائفه البيولوجية المختلفة. كذلك الوضع بالنسبة للوحة الفنية، لا يمكن تحليلها إلى كمية الألوان المستخدمة فيها، ولا القصيدة إلى الألفاظ التي تكوِّنها. صحيح أن المسجد مبني من عدد محدد من الأحجار ذات شكل معين وبنظام معين، ومن كمية محددة من الملاط والأعمدة الخشبية، إلى غير ذلك من مواد البناء.. ومع ذلك، فليست هذه كل الحقيقة عن المسجد، فبعد كل شيء هناك فرق بين المسجد وبين معسكر حربي.
الفرق الحاسم بين الإنسان والحيوان ليس شيئًا جسميًا ولا عقليًا، إنه فوق كل شيء أمر روحي يكشف عن نفسه في وجود ضمير ديني أو أخلاقي أو فني. ومن ثم، فإنه لا يصح التسليم بأن ظهور الإنسان حدث في الزمن الذي بدأ يسير قائمًا، أو عندما تطورت يداه أو لغته أو ذكاؤه كما يقرر العلم، ولكن ارتبط ظهور الإنسان بظهور أول ديانة فيها محرمات.
حتى وقت قريب، كانت نظرية «داروين» تُعتبر هي التفسير النهائي لأصل الإنسان، مثلما كان يُعتقد أن نظرية «نيوتن» هي النظرية النهائية بالنسبة للكون. ولكن لما أصبحت فكرة «نيوتن» الميكانيكية عن الكون مشكوكًا في صحتها، كذلك أصبحت نظرية «داروين» عن الإنسان في حاجة إلى تجديد. فنظرية التطور لم تستطع أن تفسر بطريقة مقنعة ظهور التدين في الحياة البشرية، ولا وجود هذه الظاهرة في العصور الحديثة. لماذا يصبح الناس نفسيًا أقل شعورًا بالاكتفاء عندما تتوافر لهم متع الحياة المادية أكثر من ذي قبل؟ لماذا تزداد حالات الانتحار والأمراض العقلية مع ارتفاع مستويات المعيشة والتعليم؟ ولماذا لا يعني التقدم مزيدًا من الإنسانية أيضًا؟ إن العقل ما إن يقبل برؤية «داروين» و«نيوتن» وهي رؤية محددة شديدة الوضوح يصعب عليه رفضها. فعالم «نيوتن» ثابت ومنطقي ودائم، وكذا إنسان «داروين» بسيط ذو بعد واحد، إنه يكافح من أجل البقاء، يُشبع حاجاته وأهدافه من أجل عالم وظيفي. لكن «أينشتين» هدم وَهْم «نيوتن». كما أن الفلسفة التشاؤمية وإخفاق الحضارة يفعل الشيء نفسه بصورة الإنسان الدارويني
إن العدمية ليست إنكارًا للألوهية بقدر ما هي احتجاج على حقيقة أن الإنسان غير ممكن وغير متحقق.. هذا الموقف ينطوي على فكرة دينية لا فكرة علمية عن الإنسان وعن العالم. فالعلم يزعم أن الإنسان ممكن ومتحقق ولكننا في التحليل النهائي نجد أن ما هو متحقق في نظر العلم شيء لا إنسانية فيه
والحضارة في خلقها الدائم لضرورات جديدة وقدرتها على فرض الحاجة على من لا حاجة له، تعزز التبادل المادي بين الإنسان وبين الطبيعة وتُغري الإنسان بالحياة البرانية على حساب حياته الجوانية. «وانتج لتربح، واربح لتبدد» هذه سمة في جبلَّة الحضارة. أما الثقافة (وفقًا لطبيعتها الدينية)، فتميل إلى التقليل من احتياجات الإنسان أو الحد من درجة إشباعها، وبهذه الطريقة توسع في آفاق الحرية الجوانية للإنسان
ويطور المؤلف موضوع الصدام بين الثقافة والحضارة بطرق مختلفة. فالثقافة عنده «هي تأثير الدين على الإنسان وتأثير الإنسان على الإنسان»، بينما الحضارة هي تأثير العقل على الطبيعة.. تعني الثقافة الفن الذي يكون به الإنسان إنسانًا، أما الحضارة فهي فن يتعلق بالوظيفة والسيطرة وصناعة الأشياء، تامة الكمال.. الحضارة هي استمرارية التقدم التقني وليس التقدم الروحي.. كما أن التطور الداروني هو استمرارية للتقدم البيولوجي وليس التقدم الإنساني. الثقافة شعور دائم الحضور بالاختيار وتعبير عن الحرية الإنسانية، وخلافًا لما تذهب إليه الحكمة الإسلامية بضرورة كبح الشهوات، يحكم الحضارة منطق آخر جعلها ترفع شعارًا مضادًا: «أخلق شهوات جديدة دائمًا وأبدًا». الحضارة تُعلم أما الثقافة فتنور، تحتاج الأولى إلى تعليم والثانية إلى التأمل.
إن التقدم العلمي مهما كان واضحًا بارزًا، لا يمكنه أن يجعل الأخلاق والدين غير ضروريّين. فالعلم لا يعلّم الناس كيف يحيون، ولا من شأنه أن يقدّم لنا معايير قيميّة. ذلك لأن القيم التي تسمو بالحياة الحيوانية إلى مستوى الحياة الإنسانية تبقى مجهولة وغير مفهومة بدون الدين، فالدين مدخل إلى عالم آخر متفوّق على هذا العالم، والأخلاق هي معناه
والاختلاف قائم بين البحث العلمي وبين استخدام نتائجه، فالحاجز وراء البحث العلمي هو فهم العالم، وأما الحافز من وراء الاستخدام، فهو غزو العالم. ولهذا السبب، لا ينظر العالِم إلى العلم بالعين نفسها التي ينظر بها الآخرون. فالعلم بالنسبة لجمهور الناس ليس أكثر من جِماع نتائج من نوع كمّيّ آلي في غالبيتها. أما بالنسبة للعالِم الذي يقوم بدور الفاعل، فالعلم بحث وخبرة وجهد وأمل يتطلع إليه.. وتضحية.. وفي كلمة مختصرة.. حياة. وفوق كل شيء هو مصدر سعادة بالمعرفة، وشعور سام بأعلى القيم الأخلاقية. في هذه السعادة يتفوّق العالم على نفسه، ويصبح مفكرًا أو فيلسوفًا أو فنّانًا. ومن هنا ينشأ اختلاف تلقائي بين ما يكتشفه العالِمُ لنفسه وبين ما يكتشفه للآخرين. عندما تبرد حرارة العلم ويتحول إلى مجموعة من المعارف والنتائج.. عندما ينمو منفصلاً عن العالِم وحياته ـ يصبح مُحايدًا. وينتهي به الأمر أن يصبح معاديًا للدين. فالعلم من خـلال رفضـه النابـع من طبيعتـه لما وراء الطبيعـة، ومن خلال صمته الملازم بإزاء التساؤلات الجوهرية (في حياة الإنسان) يسهم في تشكيل الأفكار الإلحادية، ليس بالضرورة عند العلماء أنفسهم، وإنما بالتأكيد عند الجمهور من غير العلماء.
لا يمكن بناء الأخلاق إلا على الدين، ومع ذلك فليس الدين والأخلاق شيئًا واحدًا. فالأخلاق كمبدأ، لا يمكن وجودها بغير دين، أما الأخلاق كممارسة أو حالة معينة من السلوك، فإنها لا تعتمد بطريقٍ مباشر على التديّن. والحُجّة التي تربط بينهما معًا هي العالم الآخر.. العالم الأسمى.. فلأنه عالم آخر هو عالم «ديني» ولأنه أسمى، فهو عالم «أخلاقي». وفي هذا يتجلى استناد كل من الدين والأخلاق أحدهما إلى الآخر، كما يتجلى استقلال كل منهما عن الآخر.
عند «داروين» في «الصراع من أجل البقاء» لا يفوز الأفضل (بالمعنى الأخلاقي)، وإنما الأقوى والأفضل تكيُّفًا هو الذي يفوز. ولا يؤدي التقدم البيولوجي ـ هو الآخر ـ إلى سمُوّ الإنسان باعتباره أحد مصادر الأخلاق. فإنسان «داروين» قد يصل إلى أعلى درجات الكمال البيولوجي (السوبر مان) أو الإنسان الأعلى، ولكنه يظل محرومًا من الصفات الإنسانية، ومن ثم محرومًا من السموّ الإنساني. فالسموّ الإنساني لا يكون إلا هِبَةً من عند الله.
إن مجرد المقارنة بين قاموس المفردات المستخدمة في الأناجيل والتي وردت في القرآن يؤدي بنا إلى العديد من الاستنتاجات الواضحة، في الأناجيل، يتكرر ورود ألفاظ معينة تكرارًا ملحوظًا مثل: مبارك، مقدس، ملاك، الحياة الأبدية، سماوات، الفريسي، خطيئة، حب، ندم، عفو، سر، الجسد (كحامل للخطيئة)، النفس، تطهر، خلاص… إلخ. بينما في القرآن، نجد المصطلحات نفسها مُصاغة على صورة هذا العالم وقد اكتسبت واقعية وتحديدًا، مثل: العقل، الصحة، التطهير (الوضوء)، القوة، الشراء، العقد، الرهان، الكتابة، الأسلحة، القتال، التجارة، الفاكهة، العزم، الحذر، العقاب، العدل، الربح، الانتقام، الصيد، الشفاء، المنافع… إلخ. الإسلام لا يعرف كتابات دينية (لاهوتية) معينة بالمعنى المفهوم في أوربا للكلمة، كما أنه لا يعرف كتابات دنيوية مجردة.
يشكل الوضوء والحركات في الصلاة الجانب العقلي فيها، ووجود هذا الجانب لا يجعل الصلاة مقصورة على جانبها الروحي المجرد وإنما يضيف إليها النظام والصحة معًا، فهي ليست تأمُّلًا صوفيًا فحسب بل نشاطًا عمليًا أيضًا. يوجد بالتأكيد شيء من روح العسكرية في الوضوء فَجْرًا بالماء البارد، وفي صفوف الصلاة المتلاحمة. ولم يَغِبْ هذا المعنى عن ذهن واحد من دوريات استطلاع جيش الفرس قبل معركة «القادسية» عندما رأى الجنود متراصين في صفوف لصلاة الفجر، فقال لقائده: «انظر إلى جيش المسلمين إنهم يؤدون تدريباتهم العسكرية اليومية». والحركات الخارجية للصلاة بسيطة إلى حد ما، ولكنها تشمل جميع أعضاء الجسم تقريبًا. إن خمس صلوات في اليوم مع الوضوء (أو الغسل) ـ أولها يجب أداؤها قبل بزوغ الشمس، والأخيرة في المساء ـ وسيلة فعّالة ضد الخمول والاسترخاء.
لقد جاء فرض الزكاة استجابة لظاهرة ليست في حد ذاتها واحدية الجانب. فالفقر ليس قضية اجتماعية بحتة. فسببه ليس في العوز فقط، وإنما أيضًا في الشر الذي تنطوي عليه النفوس البشرية. فالحرمان هو الجانب الخارجي للفقر، وأما جانبه الباطني فهو الإثم (أو الجشع)، وإلا فكيف نفسر وجود الفقر في المجتمعات الثرية؟ إننا في النصف الثاني من القرن العشرين ولا يزال ثلث البشرية يعاني من نقص مزمن في التغذية. فهل يرجع هذا إلى نقص في الغذاء، أم إلى نقص في الشعور؟ إن أي حل لمشكلة الفقر ينبغي أن يتضمن الاعتراف بالذنب، إضافة إلى ذلك لا بد أن يصحبه توبة وندم. فكل حل اجتماعي لا بد أن يتضمن حلًا إنسانيًا. بمعنى أنه لا ينبغي الاكتفاء بتغيير العلاقات الاقتصادية، بل أيضًا العلاقات الإنسانية. يجب إحداث التوزيع العادل، وكذلك التنشئة الصحيحة للناس التي تقوم على الحب والتعاطف.
يبين علي عزت بيجوڤيتش أن أصل الإنسان لا يمكن أن يكون ماديًّا.. فهو ليس نتيجة تطور مادي، فالعنصر الروحي في الإنسان الذي يستعصي على التفسيرات المنطقية المادية لا يمكن أن يوجد إلا بفعل الخلق الإلهي، والخلق ليس عملية مادية وإنما فعل إلهي. ليس شيئًا متطورًا، وإنما هو فعل فجائي (كن.. فيكون). «فمنذ تلك اللحظة المشهودة، لم يعد ممكنا لإنسان أن يختار بين أن يكون حيوانا أو إنسانا، إنما اختياره الوحيد أن يكون إنسانا أو لاإنسان». وبذلك ربط علي عزت بيجوڤيتش بين الإنسان وبين الله، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يكون إنسانا إلا بوجود الله، فإن مات الله (كما يزعمون في الحضارة الغربية) مات الإنسان، أو إن نسينا الله (كما نقول نحن) فإننا ننسى أنفسنا.
يكرس «العهد القديم» فكرة الأذى بالأذى، ويكرس «العهد الجديد» العفو، فانظر إلى القرآن كيف يركّب جزئيًا من هاتين الذرتين: ﴿وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها فمنْ عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾
القرآن مستمر بثبات يكرر دعواه ذات الجانبين معطيًا إياها صيغة جديدة: هنا دعوة لربط التأمل بالملاحظة.. الأول دين، والثاني علم أو على الأرجح إرهاصات علم.
لا يحتوي القرآن على حقائق علمية جاهزة، ولكنه يتضمن موقفًا علميًا جوهريًا.. اهتمامًا بالعالم الخارجي وهو أمر غير مألوف في الأديان. يشير القرآن إلى حقائق كثيرة في الطبيعة ويدعو الإنسان للاستجابة إليها. الأمر بالعلم (بالقراءة) لا يبدو هنا متعارضًا مع فكرة الألوهية، بل إنه قد صدر باسم الله: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾. الإنسان (بمقتضى هذا الأمر) لا يلاحظ ويبحث ويفهم «طبيعةً خلقتْ نفسها»، ولكن الكون الذي أبدعه الله. ولذلك فإن الملاحظة ليست بلا هدف أو لامبالية أو خالية من الشوق، وإنما هي مزيج من العلم وحب الاستطلاع، والإعجاب الديني. وكثير من أوصاف الطبيعة في القرآن على درجة عالية من الشاعرية.
تتهم الأناجيل الغرائز وتتحدث فقط عن الروح، أما القرآن، فإنه يستعيد هذه الغرائز لأنها حقيقة واقعة وإن لم يكن فيها سموّ. يتناول القرآنُ الغرائز متفهمًا لا مُتهِمًا. ولحكمة ما، سجدت الملائكة للإنسان، ألا يتضمن هذا السجود تفوق ما هو إنساني على ما هو ملائكي
إن الدين الذي يريد أن يستبدل التفكير الحر بأسرار صوفية، والحقيقة العلمية بعقائد جامدة، والفاعلية الاجتماعية بطقوس، لا بد أن يصطدم بالعلم
إذا صح ما نقول، فإنه يوجد نوعان من المعتقدات الخرافية: النوع الأول هو محاولة العلم أن يفسر لنا الحياة الجوانية للإنسان، والثاني محاولة الدين أن يشرح لنا الظواهر الطبيعية. عندما يحاول العلم تفسير عالَم النفس، فإنه يحلله إلى مُدرك حسي، أي إلى شيء. وعندما يحاول الدين تفسير الطبيعة يشخّصها، أي يحولها إلى «لاطبيعة». وهكذا نواجه مفهومًا خاطئًا من كلا الجانبين.
إن الدين الذي يريد أن يستبدل التفكير الحر بأسرار صوفية، وأن يستبدل الحقيقة العلمية بعقائد جامدة، والفعالية الاجتماعية بطقوس، لا بد أن يصطدم بالعلم. والدين الصحيح ـ على عكس هذا ـ فهو متسق مع العلم. وكثير من العلماء الكبار يسود عندهم الاعتراف بنوع من الوحدانية. وفوق هذا يستطيع العلم أن يساعد الدين في محاربة المعتقدات الخرافية، فإذا انفصلا يرتكس الدين في التخلف ويتجه العلم نحو الإلحاد.
في الوقت الذي يؤكد فيه الإسلام على عظمة الإنسان وكرامته ويُبدي واقعية شديدة، تكاد تلغي البطولة عندما يتعامل مع الإنسان كفرد. فالإسلام لا يتعسف بتنمية خصال لا جذور لها في طبيعة الإنسان. إنه لا يحاول أن يجعل منا ملائكة، لأن هذا مستحيل، بل يميل إلى جعل الإنسان إنسانًا. في الإسلام قدْرٌ من الزهد، ولكنه لم يحاول به أن يدمر الحياة أو الصحة أو الفكر أو حب الاجتماع بالآخرين أو الرغبة في السعادة والمتعة. هذا القدْر من الزهد أُريد به توازنًا في غرائزنا، أو توفير نوع من التوازن بين الجسم والروح.. بين الدوافع الحيوانية والدوافع الأخلاقية
وهكذا تبلورت أكبر حقيقة حاسمة في تاريخ الأديان وفي تاريخ العقل الإنساني بصفة عامة ـ تميزت بظهور «دين العالمَيْن»..، أو ظهور النظام الذي يحتضن الحياة الإنسانية بكل جوانبها. وتحقق الإنسان أنه ليس في حاجة إلى أن يرفض الدين من أجل العلم، أو يتخلى عن الكدح في سبيل حياة أفضل من أجل الدين
لا يمكن للإنسان أن يكون مسيحيًا حيث إنه ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن يوجد الإنسان فقط مجرد حقيقة بيولوجية أو عضوًا في المجتمع ـ إنه لا يستطيع أن يستغني عن عيسى. لا يستطيع الإنسان أن يحيا وفقًا لعيسى ولا أن يحيا ضده. وكل قدر الإنسان على هذه الأرض أن يأخذ موقعًا بين هاتين الحقيقتين المتضادتين. ومن هنا جاءت أهمية الإسلام باعتباره الحل الأمثل للإنسان، لأنه يعترف بالثنائية في طبيعته463. وأي حل مختلف، يُغَلّب جانبًا من طبيعة الإنسان على حساب جانبه الآخر، من شأنه أن يعوق انطلاق القوى الإنسانية أو يؤدي إلى الصراع الداخلي. إن الإنسان (بطبيعته الثنائية) أكبر حجة للإسلام.